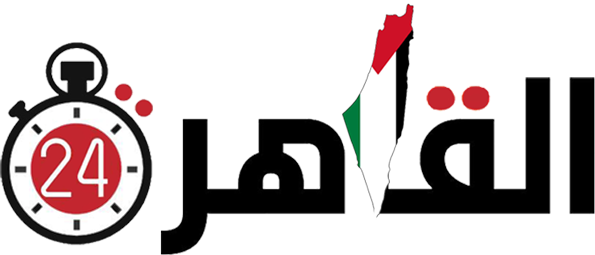رسائل من طرابلس.. فبراير 2022 بلدية سوق الجمعة (5)
يستيقظ صاحبنا في التاسعة صباحا، الصباحات هنا دسمة، كحليب الأرياف المصرية، السماء صافية ما أجمل روح صاحبنا السحابات تتدلى كعناقيد العنب على الشرفات، الشمس حانية في مكان وحامية في آخر، الشوارع مزدحمة بالسيارات والمشاة هنا قليلون جدا، يبدأ الطقس الصباحي للفتى صوت عبدالباسط عبدالصمد (.. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل..) فيذوب ويرقص وترق جوانحه، يذهب إلى المطبخ ويعد قهوة عربية ويجلس في الصالة المقابلة للمطبخ يرتشف رشفة ويعانق آيةً محكمة رقيقة عذبة كأنها نُزلت من السماء لتوِّها، رشفة وعناق وهكذا إلى أن أتم الصوت الشجي الشهي قراءته، بحث عن السجائر فوجدها في غرفة النوم أتى بها واشعل سيجارة لكنها هذه المرة عادية غير ملفوفة لقد انتهى من تدخين الملفوف ويالحكمة الله ولطفه، حين سألته عن هذا الأمر وتداعياته أقسم لي إنه لم يشعر بأي شيء مختلف، فقط القليل من الصداع ما كان يعانيه في الأيام الأولى، حتى أنه استغرب في نفسه لكنه تذكر أن هذا من لطف الله لقد ظل يدخن هذا النوع طيلة خمسة عشر سنة كاملة، ولم يظن مرة مجرد الظن البائس أنه يستطيع أن يتوقف عنه، قاطعته وقلت له، إن المناخ ضروري جدا في تغيير العادات وتعديل السلوك، ابتسم وقال لي لكن عناية الله أهم وأولى وطلب العناية يستلزم الإيمان وهذا بدوره قوة مهولة وأنا لم أفكر يوما في هجر بلادي لأنني في حاجة لتغيير شيء ولم أتعامل مرة مع هذا النوع من التدخين على أنه عادة سيئة أو شيء أأسف عليه، إنني يا صديقي بكل صراحة كنت أملأ به لياليَّ الفارغات وكان يساعدني على الاستغراق في القراءة ولمس روح الكلمات، لكني مع الوقت انصدمت إذ وجدتني لا إراديا أربط بينه وبين تميزي في الكتابة والقراءة، ناهيك عن أنه كان يستهلك كل ما في جيبي وكم تعرضت للاقتراض من القريب والغريب، ومع ذلك لم أفكر جديا في الانقطاع عن تدخين هذا النوع، كل ما في الأمر أنني حين هبطت بي الطائرة هنا إلى هذه الأرض الجديدة، وحين تنسمت فيها أول هبة نسيم شعرت بأشياء كثيرة تخرج مني وأخرى جديدة تتسرب إلى داخلي، وبعد مرور أول يومين من دونه قررت أن استمر في نسيانه والتوقف عنه وكنت حينها غارق في حالة شجن مستمر وحواسي متحفزة متطلعة، وقد أعجبتني هذه الحال الجديدة وقد شعرت بيد الله التي شعرتها من قبل في مصر وحكيت لك عنها، السحاب في متناول يدي والسماء من قربها كأنها لونتني بلونها الأزرق والشمس التي وقفت تحتها كثيرا لعلاج عظامي ومفاصلي ها هي تملأ عيني وترحب بي وتداعب جسدي، كل شيء من هذا ربطتُه في ذهني بالعناية لذلك تجدني كلما حدثتك في أمر قلت لك عناية الله، وعاد صاحبنا إلى قهوته العربية وارتشف منها وأشعل سيجارة أخرى وانتهى منهما وانطلق إلى الحمام ليتوضأ ثانية ويصلي الصبح. ذهب إلى غرفة النوم وغير ملابسه وارتدى أجملها (بنطال رمادي غامق وقميص أبيض وبالطو رصاصي وكوفية زقاء، وحذاءه الأسود) وانطلقَ، البيتُ في منطقة يطلقون عليها الترسانة وبجوار البيت تقع المقابر (مقابر القصيَّة)، دائما الراحلون يتبعونك أيها الفتى أينما حللت، ألا يكفي أنهم يسكنونك ويملؤون كل ليلة أحلامك مع كل ذهاب وإياب يسلم عليهم ويقرأ لهم الفاتحة ويدعو لهم ولأمه وأبيه وإخوته الراحلين، يقطع الشارع بمحازاة سور المقابر، ويصل إلى الشارع الرئيسي، يمشي مسافة قصيرة ثم يلتفت إلى يساره لقد آثار فضوله هذا المبنى العتيق وهذه المحلات إنه يشبه مباني ومحلات وسط القاهرة القديمة، ممراتٌ كثيرة تفضي إلى بعضها يتخللها الكثير من الدكاكين المختلفة هذا دكان قماش وهذا اكسسوارات نسائية وهذا دكان أزياء أمازيغية وآخر متخصص في الزي الليبي التقليدي، وآخر في الملابس الحديثة والبدلات المستوردة، وهذا في العطور وهذا لبيع الساعات الفخمة وذلك لإصلاحها، وهكذا إلى أن ينتهي المبنى الذي يشغل مسافة ليست قليلة من طول الشارع مع استحواذه على ناصية كبيرة تتقاطع فيها الطرق كما تتقاطع مصائر البشر، ومن هنا يمكنه أن يرى المكان الذي يقصده إنه ذاهب لمقهى حديث اسمه (كافي لاتيه) كانوا قد ذهبوا إليه مرة قبل ذلك وأعجب صاحبنا به وبإطلالته ولأنه به مكان مخصص للمدخنين، وصل المقهى وصعد إلى الدور الثاني ألقى السلام على الكاشير والعاملين وطلب مشروبه (قهوة مَعَدَّله وبريوش بالعسل والزبدة وزجاجة ماء) وهذه المدينة مشهورة بهذا الطبق المسمى (بريوش) وهو عبارة عن قطعة الخبز الأفرنجي محلاة (كرواسو) ويضاف إليها حسب طلب الزبون، مرة شيكولا سائلة مرة عسل مرة جبنة وزعتر وهكذا وانطلق إلى البلكون المخصص للرجال وجلس إلى طاولة تطل مباشرة على السماء الواسعة والشارع الطويل، في مقابله مبنى من أيام الإيطالين هو الآن مقر لبدية سوق الجمعة، مبنى رائع مستطيل ذو قبتين على اليمين واليسار وأمامه من الجهتين شجرتان كبيرتان من أشجار عيد الميلاد، وهي كثيرة جدا هنا في العاصمة طرابلس فلا يخلو شارع أو ساحة منها لدرجة جعلتني أتساءل وأبحث عن سبب كثرتها هنا، ربما يعود تاريخها للفتح الروماني القديم. جلس صاحبنا ينظر للشمس ويتلذذ بأشعتها، ويستعد لإجراء محادثة هاتفية، وكان قد حاول إجراءها أمس لكن شغله وعكر مزاجه عراكٌ عابر بين صاحبة البيت الذي يسكن فيه وأحد السكان، (إنها على ما يبدو لي تحبه وتريده بأي طريقة). يطل صاحبا على بلدية سوق الجمعة، لقد جاءه العامل المهذب بطلبه وها هو يأكل قطعة البَريُوش بتأنٍ وروية كأنه يداعبها ويقبلها، وأمسك هاتفه وبدأ الكتابة، إنه منذ هبوطه من الطائرة ودخوله لهذه المدينة الساحرة وهو في حالة كتابة مستمرة لا يقطعها إلا التأمل أو التجول في الساحات والشوارع ومقابلة الأصدقاء الجدد، إنهم لا يستوعبون كم هي جميلة مدينتهم، ولم يكونوا يلاحظون قبل أن يشير إليهم أنَّ السماء هنا أكثر صفاء والسحاب أنقى وأقرب، ألهذا الحدّ شوهت الحربُ وطائراتُ النّيتُو نظرتهم لسمائهم كما شوهت أرضهم وبيوتهم، فجأة وجد شابا ذا لحية طويلة أمامه يستأذنه أن يجلس قليلا فقال له تفضل سأله الشاب:
(من وين إنت؟ وليه ديما تشبح لفوق في شيء خويا نساعدك فيه؟) ابتسم وقال انا أنظر لفوق لأني أحب السماء والنظر إلى الشمس وأنظر لهذا البناء لأنه أعجبني وأنظر قليلا للناس لأن هذه هي المرة الأولى التي أترك فيها بلادي وأسافر، قال له (ديما إنت يا أستاذ تحرك أصابعك يديك كيما العازف، وتتحدث مع روحك)، فأجابه أنا أحب الموسيقى والغناء، وأحدث نفسي حين أكون مستغرقا في الكتابة، فهتف أنت شاعر مصري، وتهلل وجهه وقال لا تؤاخذي بالله يا أخي هذي بلادك وكلنا تحت أمرك، وأنا أخوك وصاحب هذا الكافيه. وانصرف إلى حال سبيله وبعد قليل جاء العامل بكوب من القهوة وزجاجة ماء وقال: (هذي تحيتك من صاحب القهوة)، فأطرق وحدث نَفسَهُ، أنْ يحييك إنسان أمر عظيم، ومن حيَّاك فقد أحيَاك ومن ابتسم لك فقد ابسمَك،ومن شدّ على يدكِ فقد ثبت رُكْنَك ومن ربتَّ على كتفك فقد أزالَ همك. وهنا تذكر دعوةَ أمه قديما: (الله يحبب فيك خلقه ويوقف لك ولاد الحلال) وابتسم وعاد إلى هاتفه وبدأ مكالمته. وبعد السلام والاطمئنان على أحوال بعضهما أخذ الحوار يتشعب حتى وصل لأيام الجامعة فسألته أتذكر الأستاذ الذي حكيتَ لي عنهُ أعجبني جدا ما قلت لي، هل لك أساتذةٌ أخرون تحبهم مثله احكي لي أرجوك، أنا أحبُّ حكاياتك خصوصا وأنت تتحدث عن أهلك أو أساتذك. فيرد عليها: وأنا أحبك أنتِ، ويضحكان، ويروي لها قصةَ أستاذ النقد صاحب الصوت المنطلق المغرد.