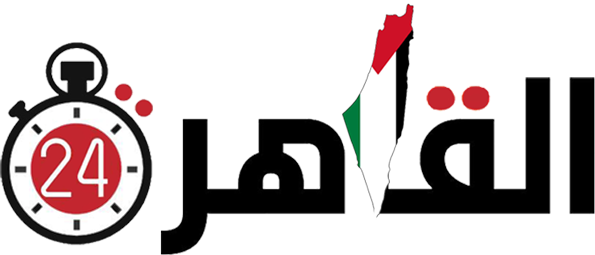جرائم هزت عرش الإنســانية
تُعَدُّ الجرائم التي تحدث في المجتمع من الأمور التي لا يمكن غَضّ البصر عنها، ولا عَن أسبابها، ولا يمكن - بأيّ حال من الأحوال - التعامل معها على أنها جرائم فرديَّة شاذة، ولا يمكننا التعامل معها على أنها جريمة رأي عام وسيتم معاقبة الجاني عليها، ومع الوقت سينال النسيان منها ليلتهمها في جوف أمعائه؛ لتخرج بعد فترة أفعال تشبه القاذورات من بشاعتها ومدى جُرمِهَا.
نحن أمام جرائم تقشعر لها الأبدان، تحدث نتيجة أسباب لا يمكننا غضاضة البصر والبصيرة عنها أكثر من ذلك، جرائم تجعلنا نستحضر آيات من كتاب الله، كتاب الله الذي نال حظه من النسيان داخلنا! لتذكرنا نحن البشر أننا نسينا حكمة القرآن، وابتعدنا كثيرًا عن آداب وأحكام ديننا الحنيف، قال الله تعالى في سورة الروم: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} صدق الله العظيم.
إن جريمة الإسماعيلية المؤلمة الذابحة للإنسانية في أبشع صورها القاتمة، التي تعبر عن استوحاش الإنسان، لم تكن الأولى من نوعها، ولكنها الصادمة من حيث التأثير، تجعلنا نقف أمام أنفسنا لنحاسبها؛ لأننا بالفعل أصبحنا جناة دون استثناء لأحد منّا، فعــندما يقف الجموع ليرفعوا هواتفهم لتصوير جريمة قتل في وضح النهار، وكأنه مشهد يُعرض من فيلم رعب، دون أن يتحرك أحد ليدافع عن القتيل، أو دون صدور ردة فعل بسيطة تَنمّ عن الرفض لِمَا يحدث!! هنا لا بد أن نقف جميعًا وقفة مع النفس أمام مجتمعنا؛ لأن مرض انعدام الرحمة تفشى فينا، وقضى على بصيص الأمل الذي من الممكن أن يعلن أن الضمائر لا زالت حيّة، لكن الحقيقة المُرة أن ضمائرنا ماتت والقسوة نالت من قلوبنا، والدليل القاطع ما حدث؛ حيث قتل أحد المدمنين لمخدر الشابو مواطنًا يبلغ من العمر 51 عامًا، وقطع رأسه باستخدام الساطور، وحملها ومشي بِهَا في شارع طنطا؛ ما أدى لحالة من الذعر والرعب بين المواطنين.. مشي برأس القتيل أمام الناس جميعًا دون خوف أو تراجع أو ندم، والناس نيام، وجبناء، ولم ينتبهوا إلا للهاتف الغبي الذي بين أيديهم! لا أبالغ، لكن الناس ردود أفعالها كانت أغرب، فوقت الحادث أخرجوا الهاتف من جيوبهِم، وأخذ كلٌ منهم يحقق السبق في التصوير لنفسه؛ ليرفعها بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أو ليضعها حالة على الواتساب؛ ليتباهى كل من كان في موقع الحادث أنه شهد وقت الجريمة!
ولم تكن حادثة الإسماعيلية الغريبة المقززة الأولى من نوعها، ولكنها الأبشع والأكثر فظاظة، سببها ظاهريّا مخدر يسمى الشابو أو الشبو، وهو مخدر من ضمن المخدرات الكثيرة، مثل: الإستروكس، والهيروين، وغيرهما التي لا تُعد ولا تحصى.
ومخدر الشابو مخدر يتمّ استخراجه من مادة الميثامفيتامين المنشطة للجهاز العصبي، ويتم وتصنيعه معمليًا في شكل بلورات أو حبيبات كريستالية زرقاء وبيضاء لامعة، ويتم حرقه واستنشاق غباره عن طريق الأنف أو الفم، ويظل متعاطي الشابو لمدة أربعة أيام في حالة يقظة مستمرة، يستطيع أن يعمل دون توقف، لكنه مغيب عن الوعي، وبعد انسحاب الجرعة من جسمه من الممكن أن يظل نائمًا دون حركة لمدة يومين كاملين، أي في حالة من الغيبوبة. تلك الجرائم تغيب فيها العقل، فماذا عن الجرائم التي تغيب فيها الضمائر والإنسانية؟!
ومنها الجريمة الأكثر بشاعة واستنكارًا، حيّث دسّت ابنة لوالدها عقاقير علاج السكر في طبق ملوخية، ولم يكفها هذا، بل قامت بحبس أنفاسه هي وخطيبها؛ حتّى إن الجثة تخشبت على وضع الاستغاثة، وستبعث يوم القيامة على وضعها؛ لتشهد على جريمة عقوق الأبناء للآباء وقسوة القلب، هل يكفي الابنة هذا؟! لم يكفها، بل ألقت جثة أبيها بمقلب القمامة الخلفي لمنزلها؟! أين الرحمة؟! أين وصيّة القرآن ووصيّة رسوله بحق الآباء على الأبناء؟! تلك الابنة التي هي قطعة من أبيها أصبحت السكين الغادر المسموم الذي طعنه من ظهره، هذا الأب الذي كان يأكل لقمة العيش المغموسة بالسّم والغدر، وقسوة الحياة بكُلّ أمان؛ لأن الطعام مُقدمًا من يد فلذة كبده الخائنة!
الجريمة الثالثة: التي جعلتني أستشعر أننا نعيش أقذر حقبة إنسانية في تاريخ البشريّة؛ حيث قتل ابن أمه العجوز التي بلغت من العمر الثالثة والثمانين، أي في عقدها الثامن، قام بتعرية شرفه وعرضه، المرأة التي لم تكن ولن تكون مثل أي امرأة أخرى، هي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حقها إن الجنة تحت أقدامها، عرى أمه وذبحها بسكين، وفصل رأسها عن جسدها، وألقى بها في ترعة أمام بيتها؛ والسبب الميراث.
الجريمة الرابعة: التي كادت أن تقترب من ساحة الجامعة بجامعة الإسكندرية؛ حيث شرح طالب بكلية الحقوق جسد أحد الطلاب بسلاح أبيض؛ لفرض السيطرة، وليثبت أنه بذلك قويٌ لا يخشى أحدًا، وأنه فوق القانون وفوق تعليمات الجامعة، ذلك الطالب بكلية الحقوق قد سبب لزميله بكلية الآداب عاهات مستديمة ستبقى معه العمر كله، بل إنها ستحتاج لجراحات تجميل، جريمة نفذت أمام بوابة الكلية، ولم يتحرك أمن الجامعة، ولم يتحرك الناس، بل صوّروا المشاجرة بالكامل! بشكلٍ يدمي القلب أخذ يضربه بالسكين في رقبته، وفي صدره إلى أن فقد الطالب وعيه، ودخل العناية المركزة.
الجريمة الخامسة: أخ يستدرج أخته، ويجبرها لتتنازل عنّ الميراث بالمنصورة، وذلك تحت تهديد الضرب والسحل، ولم يكفه الأمر، بل حاول مع صديقه الذي شاركه الجريمة أن يعتدي عليها جنسيًا، بأن يجعلها تخلع ملابسها؛ ليجبرها على التصوير معه عارية في أوضاع مُخلة؛ ليبتزها من أجل أن تتنازل عن ميراثها.
إن المشكلة أصبحت كبيرة، والمجتمع أصبح أكثر غرابة، وطرق الانتقام بها شيءٌ من القسوة والغدر والاستوحاش، فأين ذهبت الرجولة، والنخوة، ومبادئ ديننا؟! بدلًا من أن يكون الأخ عضدًا لأخته أصبح هو من يدنس شرفها بكُلِّ انعدام للمروءة والنخوة، وغياب للدين أمام شهوة المال.
إضافة لتلك القضايا هناك قضايا تصوير الأزواج لزوجاتهم في أوضاع مُخلة تحت تهديد السلاح؛ من أجل التنازل عن حقوقها، أو لطلبها الطلاق؛ لانعدام المودة والرحمة بينهما، واستحالة استكمال الحياة. جريمة وراء جريمة وراء جريمة؛لينخر غول التوحش والقسوة والغدر في مجتمعنا؛ لتغب عنّا خصائل حميدة؛ مثل: الرحمة، ولين القلب، والمروءة، والأخوة، وصلة الرحم، وزيارة المريض، والدفاع عن الشرف والعرض، ألم يقل رسولنّا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ"، ألم يقل أيضًا فيما رواه أَبو هُريرة - رضي الله عنها-، بأنه قالَ: "جاء رجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ فَقَال: يَا رسولَ اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلا تُعْطِهِ مالكَ. قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَاتلني؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرأَيت إنْ قَتلَني؟ قَالَ: فَأنْت شَهيدٌ. قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ". رواهُ مسلمٌ.
جرائم عديدة إن ذكرتها بتفاصيلها سأحتاج أكثر من مقالة مجتمعيّة ناقدة لأكتـــب عنها، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك أكثر من عامل مشتركٍ في تلك الجرائم التي تتشابه في تفاصيلها، تلك العوامل هي:
1- غياب التوعيّة الدينية رغم كثرة البرامج والقنوات:
نحن أمام مشكلة لا يُستهان بها عندما تتعدد قنوات الدعوة الإسلامية، ويغيب عن الشيوخ توعية الناس، وتخصيص دروس عن الرحمة، وخصائل الأخلاق الحميدة، وكأن دور الشيوخ أصبح الرد عن مسائل الحياة الزوجية، وعن دخول الحمام بالقدم اليسرى أم اليمنى، وحلقات السؤال والجواب على المتصل، والرد على تفسير الأحلام، أو تخصيص حلقات ملخصها لن تُفيد المُشاهد؛ لأنها ببساطة موضوعات لا تُعرض على العامة، بل مكانها مجالس العلم، فنحن إذن أمام مشكلة كبرى لغياب الدين وتعاليم الدين التي تفيد الشباب والأطفال في حياتهم، نحن لنا حق في علم مشايخنا، نحن نحتاج لعلم يفيدنا بحياتنا نحن نحتاج لإعادة تفكير وفكر مستنير يحرم كل فعلٍ شاذ، ولا نعطي له تبريرًا.
2 – اعتبار الدين مادة ثانوية:
أضف إلى ذلك مادة التربية الإسلاميّة ومادة التربية المسيحية، عندما تصبح تلك المادة ثانوية، بدلًا من أن تدرس على أساس أنها أصل الحياة لإخراج الفرد، واعيًا، وناضجًا، ومدركًا للقيم الإنسانية، وعارفًا بالحلال والحرام، ومؤمنًا أن دينه نهاية المطاف للرحلة الإنسانية، فما الإنسان وعمره إلا لحظة، وعمله هو الذي يوضع في كفة ميزانه، فإمَّا الجنة أو النار، وأليس الإنسان بحاجة إلى قوانين وقواعد وأخلاق؛ تُرتب حياته، وتُقومها، وتضبط سلوكياته وتصرفاته؛ حتى يمتاز عن البهائم.
3- دور الأســرة:
أعيّ جيدًا مدى الظروف والضغوطات التي تعيشها الأسرة المصرية، لكن هذا لا ينفي ضرورة توعيّة الآباء لأبنائهم، ولا ينفي دورهم في رعايتهم، نحن في حاجة إلى آباء لا يتسببون في عقوق أولادهم، فهم البذرة التي نسقيها بما نريد أن نراهم عليه، فإن استقت بالحنان، والرحمة، وقيم الدين، وغرز روح المسؤولية، وروح القدوة، كبرت ونمت وترعرعت واستقامت بالحب والمودة والرحمة والبر، ألم يستنكر الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عقوق أب لابنه؛ ليفاجئه أمير المؤمنين بأنه هو الأب الذي عاق ابنه: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابنه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويُحسن اسمه، ويُعلمه الكتاب (القرآن). فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئًا من ذلك: أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلًا (جعرانًا)، ولم يعلمني من الكتاب حرفًا واحدًا. فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسئ إليك...".
4- دور الفن والأفلام والمسلسلات:
أضف إلى ما ذكر الفن، عندما تصدِّر لنّا المسلسلات -ولن أذكر اسم الممثل الذي أقصده، ولن أذكر مسلسلاته ولا أفلامه التي أكره ذكرها-صورة البلطجي في ثوب المظلوم المغلوب على أمره الذي يبحث عن حقه، بل يتم وضع مشاهد للتعاطف معه، فنحن نقدم للمجتمع إسفافًا مستخفين بعقول المشاهدين لنضع السمّ في العسل، عندما نجعل المظلوم متحايلًا في المسلسلات على القانون، فنحن نستبدل قانون الإنسانية بقانون الغابة، وهنا يتساوى الظالم مع المظلوم، فيضيع الحق بينهما.
إذن أين قيمة الفن التي تقدم إلى المجتمع؟! أين أعمال نور الشريف: العطار والسبع بنات، وآخر الرجال المحترمين، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى الفخراني: سكة الهلالي، وونوس؟ أين الأعمال التي تحترم عقل المتفرج؟ أين مسرحيات محمد صبحي، ومسلسل يوميات ونيس؟ أين دور الأسرة في مراقبة ما يشاهد أطفالهم؟! للفن دور لا يقل عن دور الأسرة؛ لأنه القوى الناعمة والوسيلة الأسهل للتأثير في المجتمع وفي العقول.
5- دور الإعلام:
ليس الإعلام بعيدًا عما أذكره، فعندم يتم تسليط الضوء على شخصيات ليست صاحبة إنجاز ولا دور مجتمعي، بل هم سبب في انحطاطه، مثل: مطربي المهرجانات التي تحتوي أغانيهم على ألفاظ سيئة، واستضافة الذين يفعلون أفعالًا شاذة كالمحلل الشرعي، وتصديرهم للمجتمع على أساس أنهم الموجة الموجودة الآن، فنحن لا بد أن نسلط عليهم إصبع الاتهام؛ لتصديرهم نماذج سيئة في وقت أصبح السيئ أكثر من الإيجابي.
أمام كُل الجرائم التي ذكرتها، والتي لم أذكرها لا بد أن أقول: إنها هزت عرش الإنسانية، وجعلتني أخاف من غياب القيم والرحمة في قلوب ووجدان البشر؛ ليقفوا أمام كل حادثة يرفعون هواتفهم التي تدّعي الذكاء، وهي قطعة حديدية تقودهم للجهل والتبلد وقسوة القلب، تجعلهم بلا هدف في حياة أصبحت قاسية، فكما قال أرنست هيمينغواي الأمريكي الذي اشترك في الحربين العالميتين، يعطينا درسًا عن الحياة أشبه بحادثة أمس عن الجبن والخسة والتبلد: الجبان يموت ألف مرة، والشجاع مرة، الرجل الذي قالها أول مرة كان على الأرجح جبانًا. عَرِفَ الكثير عن الجبناء ولا شيء عن الشجعان.. الدنيا تقتل الطيّبين جدًا، اللطيفين جدًا والشجعان جدًا بلا تمييز. تقتلهم بإنصاف. إذا كنت لا أحد من هؤلاء، فتيّقن أنها ستقتلك أيضًا. ولكن لن يكون هناك داعٍ لها للاستعجال. أنا لم أعد شجاعًا يا عزيزتي. أنا مكسور بالكامل. لقد كسروني...
أرجو أن أكون سلطت الضوء على بعض الحلول، وسأختم بمقولة أضعها نصب عيني قانونًا لي: الأخلاق كالأرزاق الناس فيها بين غني وفقير.